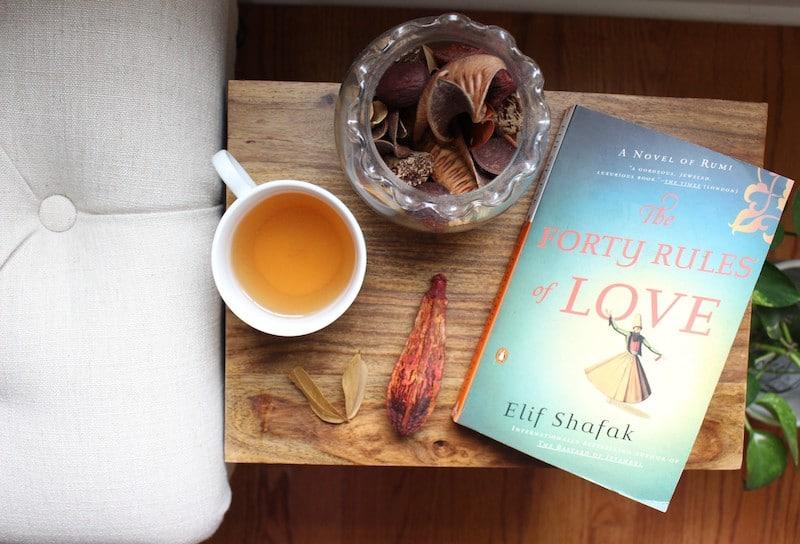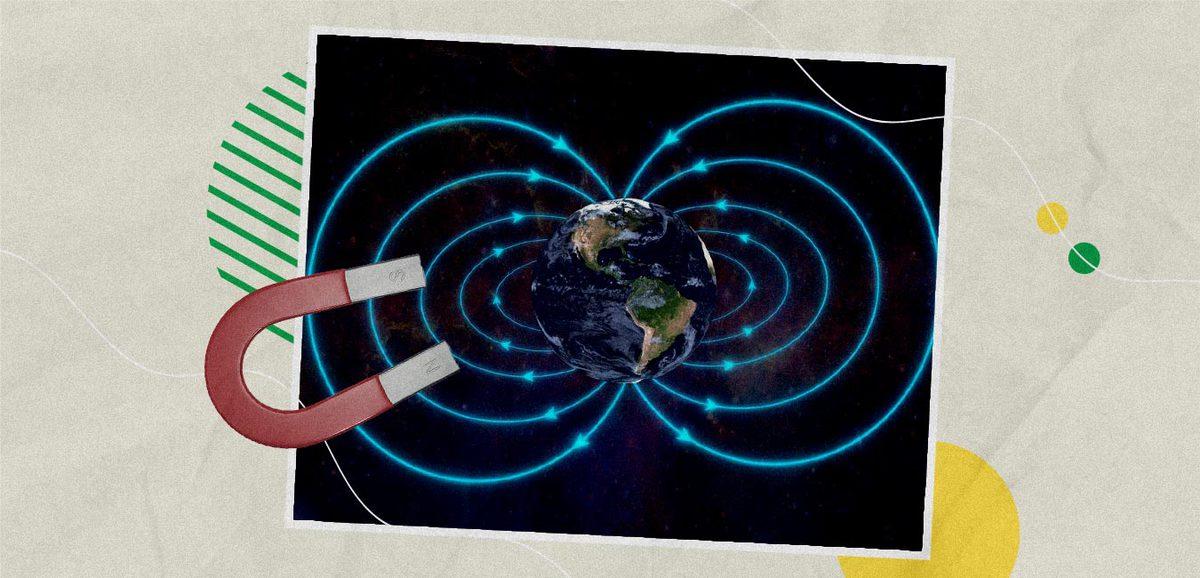رعاع الميديا: انتصار الإنسان الرويبضة
“حقيقة أنّ رأيًا ما مقبول على نطاق واسع ليست دليلًا على عدم سخافة هذا الرأي. في الواقع، في ظل النظرة القائلة بسخافة الغالبية العظمى من الجنس البشري، الرأي المقبول على نطاق واسع مرجّح أكثر ليكون رأيًا أحمق وليس معقولًا”. بيرتراند راسل
عندما سطعت شمس الغرب على العرب والعالم أجمع في الآونة الأخيرة، وهو ما لن تدركه الآن المستشرقة الألمانية سيغريد هونكة كونها قد رحلت عن هذا العالم منذ زمن، مُنشئةً وسائل الاتصال الحديثة التي سهّلت كل شيء وأتاحت الفرصة للجميع أن يعبّر ويناقش. عامت على السطح نتائج حميدة لا بد مِن الإقرار بها، إلا أنّه في الوقت نفسه ظهرت عواقب سلبية مُولّدةً جحافل مِن البلهاء وفيالق مِن مقدمي محتوى ما يطلبه الجمهور، فكان عندها لا بدّ مِن الوقوف قليلًا والتكلّم عن الغيظ الذي يجري بداخلنا من هذا.
انتظرت حتى نهاية رمضان حتى أتكلّم عن مغامرات طرزان رامز جلال، كوني لا أحب الكتابة التريندية-التسويقية، بل نقاش الموضوع بهدوء بعد الفَراغ مِن ضوضائه، خصوصًا أن هذا النمط من المحتوى أصبح رائجًا جدًا كالعناوين التي تحتوي عبارات من نمط: تحدي أكثر أندومي حارة في العالم. انظروا كيف فاجأت عمتي فماتت من فرحتها. فاجئني حبيبي في العرس. وجُمل أخرى بلهاء على نفس هذه الشاكلة. ولو أردنا فهم كل هذا الغثاء فعلينا أولًا أن نشرح بشيء مِن التبسيط المبدأ الرأسمالي السائد.
هناك عقلية ضحلة في التفكير أسميها العقلية الثنائية، وهي أنه لو لم تكن معي فأنت ضدي، أي بمجرد انتقاد الرأسمالية أو شيء ما فيها فورًا يُشار إليك بالاتهام أنك ماركسي. لا أنا لست كذلك، أنا فقط أناقش الموضوع بحياديّة كما هو.
“تتجلى هذه العقلية البلهاء بأن مَن ينتقد شيئًا في التراث الديني التقليدي يُتهم أنه ملحد. ومَن ينتقد شيئًا في الإلحاد يُتهم بأنه مؤمن متخلّف تقليدي. مَن يحاول التأييد لأحدهم يتهم بالتطبيل والتبعية، مَن يحاول التعارض يتهم بالكذب والخيانة. وهلم جرًا لنماذج العقلية الثنائية السطحية القائمة على إما السواد أو البياض. إما معي أو ضدي. الحياة ليست نظام Binary يا صديقي، إما 0 أو 1. ليست كذلك. الحياة أكبر من ذلك بكثير”.
يقوم المبدأ الرأسمالي على أساس صلب جدًا يسمى مضاعفة رأس المال. اكتساب المال موجود في كل المبادئ الاقتصادية إلا أن الرأسمالية تعتمد مبدأ المضاعفة فلو كنت كاتبًا أو صانع محتوى على يوتيوب تنشر فيديو يحوي 5 كتب مهمة متعلّقة بمجال ما، سيكون أمرًا لطيفًا يحق لك تحصيل المال من ورائه. أين تكمن اللعنة؟ تكمن عندما تريد مضاعفة المال، ماذا تفعل حينها؟ تمامًا كما يخطر في بالك الآن، تقوم يوميًا بنشر ألف مقال عن كتب يجب قراءتها وتصنع مئة ألف فيديو على يوتيوب لأجل جذب المشاهدات والمضاعفة وحتى لو كان محتواك جيدًا ومفيدًا إلا أنه يصبح فائضًا وتراكميًّا بشكل ضار، عندها تكون تمامًا أمام النمط الأوضح للرأسمالية البشعة. تقديس المضاعفة لأجل الزيادة.
تُمدح الرأسمالية دائمًا لدفعها نحو الابتكار والتجديد وهذا صحيح ومُحق، فكل المنتجات الآن هي صناعة توجّهات اقتصادية تحت المظلة الرأسمالية. لكنها في نفس الوقت تقوم بالإغراق التافه خالقةً أشياء لا حاجة جوهرية لها.
ما الفرق الصميمي بين آخر إصدار مِن آيفون والذي قبله؟ ما الفرق الجوهري بين سيارات موديل سنتها وتلك التي سبقتها؟ خصوصًا أن كلاهما سيوصلانك لنفس المكان. هناك فرق طبعًا لكنه ليس فرقًا “احتياجيًا” إنما لا يتعدى كونه مجرد منافسات بين الشركات لتكسير رؤوس والمضاعفة لا أكثر.
كلا الهاتفين يعملان بنفس الآلية لكن البعض يفضّل شراء هاتف جديد كل سنة لأن هناك ميزة جديدة قد أضيفت في تطبيق لن يستخدمه في حياته سوى مرة. غريب جدًا هذا السلوك يبدو وكأنه استدراج مُسبق غير واعٍ لحاجات نتوهم أننا نحتاجها! وتذكر دائمًا أن الحاجة للأشياء تُظهر بعد وجودها وليس قبلها. أنت الآن لا تتخيل أن تعيش حياتك بدون إنترنت لأنك أساسًا ولدت بعده أو عاصرته. لا يمكنك أن تقول أنّ الذي عاش عام 1800 لا يمكن أن يحيا بدون إنترنت! فالحاجة للأشياء لا تظهر إلا بعد وجودها وليس قبلها.
الآن نعود لرامز جلال ولكل أصحاب المقالات الإغراقيّة في المحتوى المكتوب أو المرئي المصوّر على يوتيوب وأشباههم. سبب ذلك باختصار شديد هو الرغبة في المضاعفة والنمو. الرغبة في ابتكار شيء جديد -هو غير مُهم حتمًا أو مُكرر، لكن كما قلت قبل قليل، تظهر الحاجة إليه بعد وجوده- واصطياد الإنسان بسيل لا يرحم من الإعلانات والتسويق مُستخدمين كل الوسائل الممكنة من أجل جذب المتابع، سواءً بشكل بصري أو سمعي أو حتى بشكل معنوي أخلاقي، كما يفعل بعض الذين يسوقون من خلال أغاني لها علاقة بقضايا معينة، على الرغم من أنهم لا يشترون أي من هذا الكلام بفلس واحد بل فقط يريدون المشاهدات وبالتالي مضاعفة الأعداد ومن ثمّ زيادة الأرباح. أما المستخدم والمشاهد والزائر وصاحب القضية الذي يتعاطف، فلا يملك سوى حالته النفسية البائسة بعد كل هذا الرشق من المطالب الدافعة للحركة والفعل.
لم يخطئ أفلاطون صراحةً عندما طرد من مدينته الفاضلة الشعراء والفنانين لسبب بسيط جدًا قاله: هو أنهم ينتجون الأوهام ويبيعونها. هم أطباء تخدير يصنعون الأفيونات النفسية ويحقنون المتلقي بها. أحيانًا أرى بعض الفنانين -الممثلين حصرًا- يدلون بآراء خارج سياقهم. أصدقائي الأعزاء، حبيبي أيها الممثل والممثلة أينما كنتم. كونك مشهور لا يعني أن رأيك مهم. ضع هذا الكلام في رأسك تمامًا. أنت مشهور بتمثليك -الرديء غالبًا- أو بسبب جمالكِ -دائمًا هنا- لا أكثر. غير ذلك رأيك لا يتعدى رأي أي إنسان بسيط مهما كان مستواه، لذلك لا تُعطِ لنفسك سلطة وهمية غير موجودة.
أساسًا مِن المشكوك به أن يكون التمثيل فن، نعم المسرح كذلك. لكن التمثيل خصوصًا الرديء السائد حاليًا بريء من هذا الزَعم. على العكس، أعتقد لو رأى الفن ما يُؤدى اليوم باسمه على الشاشات لرمى نفسه من الطابق العاشر وانتحر.
عندما نتحدث عن الفن يجب أن يخطر على بالنا فورًا الرسم، الموسيقا، النحت، المسرح القديم. إلا أن المشكلة بدأت مع اختراع الكاميرا أولًا ثمّ سطوع شمس الغرب على العالم بالسوشال ميديا ثانيًا، مولدين بذلك فنًّا رديئًا قائمًا على الرعاع الساعين نحو المضاعفة وإنتاج محتوى ما يطلبه الجمهور. الحشود التي تسعى للترفيه، أو حتى مجرد الفضول لرؤية الآخر وازدراءه والتنبيه منه كما أنا أفعل هنا بدوري الآن!
هذا المقال سيعجبهم، خمّنوا لماذا؟ لأنه سيرفع نسبة مشاهداتهم ولو بداعي الفضول السلبي. لكنهم لا يهتمون، ما يعنيهم فقط مضاعفة الأرقام ليس أكثر. سواءً ذهبت إليهم مادحًا أم ساخطًا غير مهم، المهم أن تأتي لهم لأنك مجرد رقم ومشاهدة وزيارة لا أكثر. لذلك وجب لأحد أن يتكلم ولو أنه سيزيد من شهرتهم إلا أنه على الأقل سيصحّي البقية بأهمية حتى عدم امتلاك فضول لرؤية هؤلاء السيئين. الحل يكمن في التجاهل الكامل وليس النقد لأن هذا سيزيد من جمهورهم ولو بدافع الاستهزاء.
لا جدال في أن الميديا الجديدة مكّنت الكثيرين من نشر أفكار مهمة لا بد منها وساعدتهم في الظهور إلا أنها ضاعفت وسهلت عمل السخيفين أيضًا. وكون أن إنساننا العاقل يتجه نحو البلاهة أكثر وقلة التركيز وضعف الإرادة بسبب تغيير طبيعة الحياة التي نعيشها ورغبته في السرعة دائمًا وتقليل الجهد الذي يبذله. لا بد أن نشهد انتصار هؤلاء الناس، انتصار الإنسان الرويبضة. ورغم أني على يقين تام أنهم هم الرابحون وأنهم لن يتأثروا بل نحن الخاسرون دائمًا، إلا أني بنفس الوقت لا أعرف ما الذي يدفعني لفعل هذا وكتابة هكذا أشياء. صدقني لا أعرف مجرّد شيء ما داخل صدري وأردت أن أقوله ليس أكثر.
طردهم أفلاطون من مدينته المثالية لأنهم ينتجون الأوهام اطردهم أنت الآن بدورك من حياتك. لا تهتم إن أكلوا أكثر أندومي حارة على يوتيوب أو وضعوا الممثلة الفلانية في مستنقع من الذهب وليس الماء. لا تهتم، تجاهلهم بالكامل.
عندما يُقدم إليك شيء بالمجان، اعلم أنك أنت السلعة يا عزيزي. حتى الترفيه البحت لن يُعطى إليك بدون مقابل. تذكّر هذا جيدًا.
ثم إننا نعيش في وضع لا أعرف كيف يمكننا أن نترفّه بمثل هكذا أشياء. مثلًا، السويد والنرويج وكندا وغيرها مِن الدول الغنية في العالم المصنّفة كـ Welfare States. هل صدفَ أن رأيتهم يعرضون أشياء مشابهة ولها روادها بهذا الشكل الفلكي؟ غريب، كأن هذه المواضيع لا تجد تربتها الخصبة إلا في حقولنا ولا تستقطب الناس إلا الذين بين ظهورنا. ربما لأن لها جمهورًا كبيرًا محبًا سريًّا. حتى لو أنهم ادعوا العكس وأنكروا. مَن يدري؟
سطعت شمس الميديا الجديدة مِن الغرب فأنارت ظلمة الذين لم يكن لديهم فرصة للتعبير، إلا أن تلك الشمس أحرقت الآخرين. أحرقتهم بفيض من الضرر الساعي نحو المضاعفة الفائضة. أحرقتنا وجعلت الإنسان الوحيد المنتصر والمتبقي فينا هو الإنسان الرديء، الإنسان الرويبضة ولا أحد غيره.
أحلى ماعندنا ، واصل لعندك! سجل بنشرة أراجيك البريدية
بالنقر على زر “التسجيل”، فإنك توافق شروط الخدمة وسياسية الخصوصية وتلقي رسائل بريدية من أراجيك
عبَّر عن رأيك
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّةواحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.